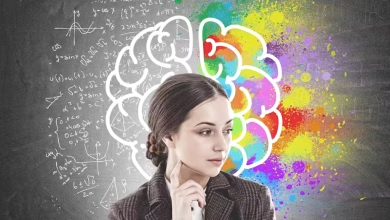السياسة والجامعة: قطيعة جيلية أم أزمة ثقة؟

في خضم واقع متقلب تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية، وتضيق فيه مساحات التعبير في بعض السياقات، يطرح سؤال جوهري عن موقع الطلبة داخل الزمن السياسي الراهن: هل ما زالوا فاعلين في المشهد؟ وهل ما زال الحرم الجامعي يحتفظ بروحه النضالية التي لطالما كانت نبضا حيويا للمجتمع ومختبرا للصراع الفكري والسياسي؟ الجواب لا يبدو بسيطا، فالسياق تغير، والجيل تغير، والرهانات كذلك.
لقد شكل الطالب الجامعي، تاريخيا، طليعة التغيير في المغرب كما في العالم العربي. من حركة 23 مارس إلى نضالات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ظل الفعل السياسي الطلابي رافعة لخطاب الإصلاح، وقاطرة لاحتجاجات اجتماعية أوسع. كان الانخراط في النقاشات السياسية جزءا من الهوية الجامعية، وكانت الساحات أمام الكليات تعج بالمناظرات والملصقات الحزبية، بل إن بعض القيادات السياسية الحالية تخرجت من تلك
“المدارس الموازية”.
لكن اليوم، تبدو الصورة مختلفة. عدد كبير من الطلبة لا يعرفون أسماء الأحزاب السياسية، أو لا يثقون في جدوى العمل الحزبي، ناهيك عن العزوف عن المشاركة في الانتخابات الطلابية إن وجدت. وتكشف المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الشباب الذين يمارسون العمل السياسي من داخل الهيئات السياسية لا تتعدى 1 في المئة، في حين تصل نسبة الشباب الذين لا يثقون في جدوى العمل السياسي إلى 70 في المئة. وهي أرقام تضع علامات استفهام كبرى حول علاقة الجيل الجامعي بالسياسة، ومدى إيمانه بجدواها، وانخراطه الفعلي في الشأن العام.
الأسباب متعددة ومعقدة. فبعض المحللين يرجعون الأمر إلى تراجع الأندية الثقافية والسياسية داخل الجامعات، وانسحاب بعض التيارات الحزبية من الحقل الجامعي، إضافة إلى ما يعتبره البعض “تأطيرا فوقيا” للحياة الجامعية جعل النقاش العمومي باهتا. بينما يرى آخرون أن الجيل الجديد يعيش انخراطا من نوع آخر، لا يمر بالضرورة عبر القنوات الحزبية، بل عبر وسائط رقمية ومنصات اجتماعية تعبر عن غضبه، قضاياه، وتمرده بلغة تختلف عن لغة الجيل السابق.
ولئن كانت الجامعة لا تزال تنتج وعيا نقديا في بعض الفضاءات، فإن هذا الوعي غالبا ما يبقى فرديا أو مشتتا، ولا يتحول إلى فعل جماعي مؤطر. المفارقة أن الجيل الحالي أكثر اطلاعا على القضايا الدولية، وأكثر قدرة على رصد الظواهر الاجتماعية، لكنه في المقابل أقل رغبة في الانخراط داخل الأشكال التقليدية للتنظيم، ما يطرح سؤالا أكبر حول فاعلية البنيات الحالية ومدى قابليتها لاستيعاب تحولات الشباب.
ففي ظل هذا الواقع المتحول، تبقى علاقة الجيل الجامعي بالشأن السياسي رهينة بتطورات متعددة: ما بين تأثير السياق المجتمعي العام، وتحولات وسائل التعبير، وتغير أشكال الانخراط. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الأدوار الممكنة للجامعة اليوم في مواكبة هذه التغيرات، ومدى قدرتها على احتضان تطلعات فئة شبابية لا تنقصها الرغبة في الفهم والمشاركة، بقدر ما تبحث عن أطر جديدة تعبر عنها وتواكب إيقاعها.