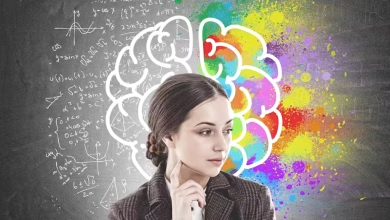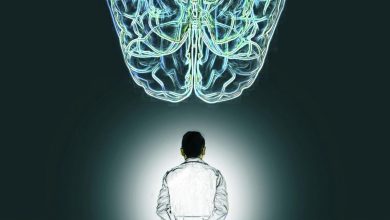المسرح… ذاكرة حية

منذ أكثر من ألفي عام، ولد المسرح في أحضان الحضارات الإغريقية والرومانية كفن حي يقف فيه الممثل أمام الجمهور، وجها لوجه، بلا وسيط ولا شاشة، ليحكي قصة، ويطرح أسئلة، ويعكس هموم الإنسان وأحلامه. من مسارح أثينا القديمة، مرورا بروائع شكسبير في القرن السادس عشر، وصولا إلى التجارب العربية التي نهلت من التراث والحداثة على يد رواد مثل مارون النقاش وتوفيق الحكيم، ظل المسرح محافظا على جوهره: التجربة الإنسانية المباشرة، حيث النفس الحي للممثل يلتقي مباشرة بنبض المتفرج.
ويلقب المسرح بـ “أبو الفنون” لأنه الفضاء الذي تجتمع فيه الفنون كلها في عمل واحد متكامل؛ فالمسرحية تقوم على النص الأدبي الذي يستند إلى فن الرواية أو القصة، وتندمج فيها الموسيقى، وأحيانا الغناء والرقص، كما تحضر فنون التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وفنون التصميم والديكور والزخرفة والإضاءة. ولا يكتمل العرض المسرحي من دون لمسات الفنون التشكيلية كالرسم، مما يجعل الخشبة مرآة تعكس تناغم الإبداع البشري بمختلف أشكاله في تجربة فنية حية.
لكن مع أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، دخلت الثقافة الإنسانية مرحلة جديدة مع صعود الشاشات الصغيرة؛ التلفزيون أولا، ثم الهواتف الذكية ومنصات البث التدفقي، التي وضعت آلاف العروض بين أيدي المشاهدين في أي وقت وأي مكان. لم يكن التغيير تقنيا فقط، بل ذهنيا وسلوكيا أيضا. حيث أصبح الجمهور معتادا على الإيقاع السريع، والتنقل الفوري بين المقاطع القصيرة، بينما يطلب المسرح التفرغ الكامل والإنصات العميق لحكاية واحدة على مدى ساعتين أو أكثر.
فالمسرح لم يكن يوما مجرد ترفيه، بل منصة فكرية وجمالية لمساءلة الواقع وكشف التناقضات الاجتماعية والسياسية. ففي العالم العربي، لعب هذا الفن دورا محوريا في لحظات التحولات الكبرى، كما في تجارب المسرح السياسي والاحتجاجي بالمغرب وتونس ومصر، حيث تحولت الخشبة إلى منبر للتعبير عن آمال الشعوب ومخاوفها. ومع ذلك، يواجه المسرح اليوم معركة قاسية في جذب جمهور نشأ في عالم تتزاحم فيه الصور والمقاطع والفيديوهات القصيرة.
ففي عصر تتسابق فيه المنصات الرقمية على سرقة انتباه المشاهد، أصبح وقت الجمهور عملة نادرة. المسرح، بطبيعته، يطلب من المتفرج التوقف عن اللهاث خلف التنبيهات والإشعارات، والتسليم لزمن آخر أبطأ وأكثر تأملا. هذا الصدام بين الإيقاع المسرحي البطيء نسبيا والإيقاع المتسارع للحياة الرقمية خلق ما يسميه النقاد ب”معركة الذاكرة الثقافية”، حيث يحارب المسرح من أجل الحفاظ على مكانته كفن يوقظ الحواس بدلا من تخديرها.
ورغم التحديات، لم يستسلم المسرح أمام طوفان الشاشات. فقد ظهرت تجارب مبتكرة لدمج الوسائط الرقمية داخل العروض الحية، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والإضاءة التفاعلية لجذب جيل جديد من المتفرجين. كما اتجه بعض المخرجين إلى تقديم عروض قصيرة أو عروض في أماكن غير تقليدية، من المقاهي إلى الشوارع، في محاولة لإعادة المسرح إلى قلب الحياة اليومية.
وعلى المستوى العربي، لا يزال المسرح يحتفظ بمكانة رمزية وثقافية، رغم أن جمهوره تقلص أمام جاذبية المحتوى المرئي السريع. لكنه يظل بالنسبة للكثيرين فضاء للحوار، وإحياء للغة العربية الفصيحة، وحافظا لذاكرة الشعوب الفنية. ففي بعض المدن العربية، تقام مهرجانات سنوية تعيد تسليط الضوء على العروض المسرحية، وتمنح المبدعين فرصة لاستعادة الجمهور، ولو مؤقتا.
فقد تتغير الوسائط وتتبدل الأذواق، لكن المسرح يظل أحد أصدق أشكال التعبير الإنساني، لأنه يقوم على الحضور الفعلي، حيث يلتقي الممثل والجمهور في لحظة مشتركة لا يمكن تكرارها. في زمن تتسيد فيه الشاشات وثقافة الاستهلاك السريع، يمثل المسرح تذكيرا بأن الفن ليس مجرد صورة تعرض ، بل تجربة تعاش. إن الحفاظ على هذا الفن العريق ليس ترفا ثقافيا، بل ضرورة لحماية جزء أصيل من ذاكرتنا الإنسانية.