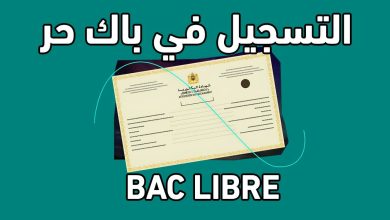لماذ لا نقرأ؟
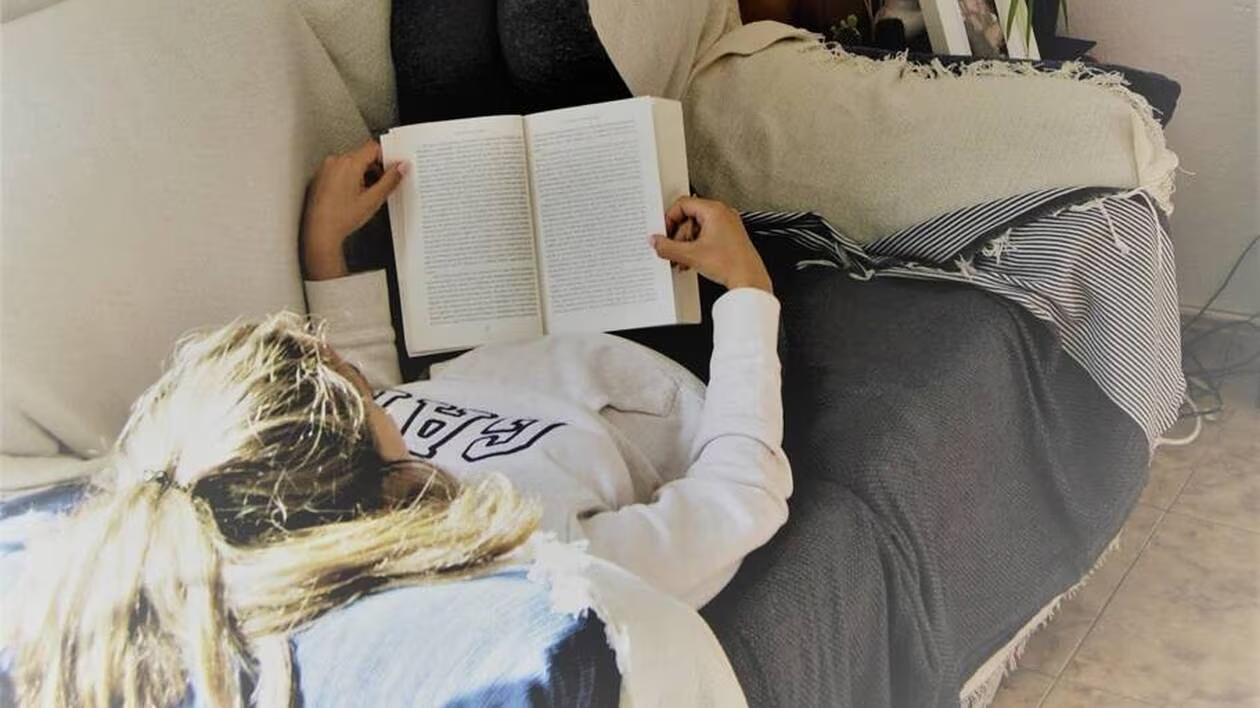
<<أحب الكتاب، لا لأني زاهد في الحياة، ولكن لأن حياة واحدة لا تكفيني.>>
عبارة كتبها عباس محمود العقاد، وقد لخصت ببراعة ما تعنيه القراءة: امتداد للحياة، واتساع للزمن، واتصال بأرواح لا حصر لها. لكنها أيضا، في ظل واقعنا العربي، تصبح جملة موجعة، لأن أمة “اقرأ” لم تعد تقرأ، أو بالأحرى، لم تعد تمنح فرصة أن تقرأ.
تقرير صادر عن منظمة اليونسكو سنة 2023 يرسم صورة صادمة لحال القراءة في العالم العربي. فبينما يقرأ الطفل الأمريكي بمعدل 6 دقائق يوميا، ويبلغ متوسط ما يقرؤه الفرد في أوروبا نحو 200 ساعة سنويا، وبمعدل يتراوح بين 10 إلى 25 صفحة يوميا، لا يقرأ الطفل العربي سوى 7 دقائق في السنة، وما يقرؤه لا يتعدى ربع صفحة فقط. إنه فرق لا يشبه الفجوة، بل الهاوية.
ولا يقف الأمر عند مستوى الأفراد، بل يتعمق أكثر حين نقرأ واقع الإنتاج الثقافي. فبينما تصدر أوروبا 100 كتاب سنويا، لا ينتج العالم العربي سوى كتابين اثنين في السنة. وما يزيد الصورة قتامة، هو مستوى الإنفاق على الثقافة. فقط 5% من الميزانية العامة في الدول العربية تخصص للثقافة والبحث، منها 1.5% فقط للبحث العلمي، مقارنة بأمريكا التي تصل فيها ميزانية الكتاب والثقافة إلى 23% من الموازنة العامة، يُخصّص منها بين 9 إلى 10% للبحث العلمي. إنها أرقام لا تدين المواطن، بل تكشف عن بنية كاملة تهمل العقل، وتخشى الكلمة، وتهمش الكتاب.
لسنا أمام مجرد عزوف عن القراءة، بل أمام أزمة تتشابك فيها الأسباب الاقتصادية والسياسية والتربوية والثقافية. فحين يظل الكتاب خارج أولويات الإنفاق لدى فئة واسعة من المجتمع، سواء بسبب محدودية الدخل أو بسبب غياب التحفيز، يصبح اقتناؤه أمرا مؤجلا أو غير ضروري. وحين يتحول التعليم إلى منظومة قائمة على التلقين لا على الاكتشاف، يتعلم الطفل كيف يردد، لا كيف يتساءل أو يبحث. نربي أجيالا تعتقد أن القراءة مرتبطة بالامتحانات لا بالحياة، وأن الكتاب وسيلة عابرة للتوظيف لا رفيق دائم للنمو الشخصي. كما أن فعل القراءة نفسه لم يتحول إلى عادة متأصلة في المجتمع، بل بقي سلوكا هامشيا، نتيجة غياب مشاريع ثقافية تنموية حقيقية تعلي من قيمة المعرفة وتدرجها ضمن أولويات النهضة. وغالبا ما ينظر إلى القراءة باعتبارها رفاها فكريا، لا حاجة حيوية، في ظل ضعف السياسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ ثقافة المطالعة في المراحل المبكرة من العمر.
أما الفضاء الرقمي، فرغم ما يتيحه من فرص، فقد ساهم بدوره في تفكيك العلاقة مع القراءة العميقة. في زمن السرعة، والانبهار اللحظي، والتطبيقات المختزلة، بات القارئ يستنزف في متابعة الصور والفيديوهات القصيرة بدل التأمل في المعاني الطويلة. غيبت الثقافة لصالح الترفيه، وتوارى الكتاب في زمن “الترند”.
ومع ذلك، يبقى الأمل في الهامش، في تلك المبادرات الصغيرة التي يطلقها شباب يؤمنون بأن القراءة فعل مقاومة، وفي الكتاب الذين يواصلون الكتابة رغم الصمت، وفي المعلمين الذين لا يسلمون للمنظومة، ويصرون على غرس البذور في عقول عطشى.
فالقراءة كانت دائما مهد الإبداع، فإن أي مجتمع يريد أن ينتج فكرا، أو يطور علما، أو يحرر وعيا، لا بد له أن يبدأ من الكتاب. الأسماء اللامعة في تاريخ الإنسانية، من علماء، وفلاسفة، ومفكرين، لم يولدوا بأفكار جاهزة، بل شقوا طريقهم عبر صفحات الكتب، واكتسبوا لغتهم من النصوص، ورؤيتهم من التأمل في ما قرأوا. وما لم نغرس في أجيالنا بذرة هذا الشغف، فإنهم سيظلون مستهلكين سلبيين في زمن غزارة المحتوى، عاجزين عن التمييز بين الرأي والمعلومة، بين الفكرة والدعاية، بين الحرية والفوضى. القراءة، في هذا السياق حصن متين لحماية الفرد من الضياع الفكري والاغتراب الثقافي. فهي التي تمنحه أدوات الفهم، وتعلمه كيف يكون مميزا ومختلفا في تفكيره، وكيف يحافظ على اتزانه الذهني، وكيف يبني رأيا مستقلا بعيدا عن التأثر بالخطابات السطحية أو المتطرفة. في زمن باتت فيه الأفكار تستهلك كما تستهلك الوجبات السريعة، تبدو القراءة كأبطأ خيار، لكنها الأعمق، والأكثر بقاء.
ولعلنا، حين نعيد للنداء الأول صداه – “اقرأ” – ننجو من موت ثقافي نعيشه بصمت.